أدنى الأولويات
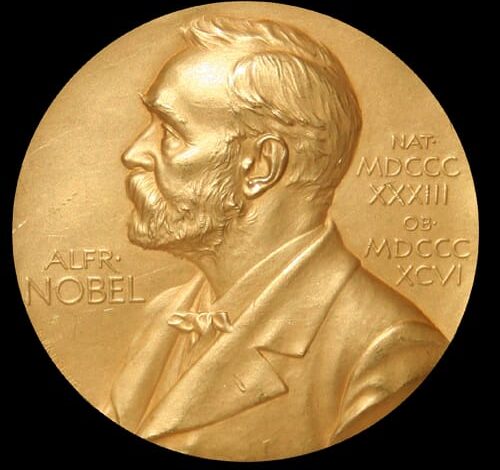
أحمد المقدم
لازال عالقا في ذهني ذلك المشهد من العام ٢٠٠٥ و الذي حمل من وداعته ما يستحضر القدر الوافر من السلام النفسي. لقد كان متأنقا في بزته بلونها الأزرق الداكن والمتناسق مع بشرته البيضاء وعثنونه الأشهب، لقد تلقى دعوة لاحتساء الشاي من ذلك العجوز ولم يكن له أن يرفض دعوته حتى وإن اضطره ذلك لأن يترك ضفاف الأمازون على متن طائرة نحو ضفاف النيل. ياله من مشهد وقد انحنى مقبلا يد ذلك العجوز بينما يربت العجوز على ظهره كامتنان له على كياسته ودماثة خلقه. لقد كان ذلك العجوز مرتديا عوينته المعهودة التى طالما كانت جزءا من شخصيته مذ كان كاتبا شابا يجوب شوارع القاهرة القديمة وأزقتها مرتشفا شايها وقهوتها على كراسي مقاهيها الشعبية المختبئة في شوارعها الضيقة والواسعة على حد سواء. لم يكن مجرد كاتبا بل رساما يرسم صورة واقعية لمحبوبته القاهرة تنبض بالحياة فكان أدبه آلة زمن تنقلنا إلى كل ما وصفه لكى نحياه كما هو.
يتذكر السيد باولو كويللو عندما استقل طائرته ليطير من ضفاف الأمازون من برازيليا قبالة ضفاف النيل ليلتقي بابن هبته مصر وعاشق قاهرتها الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ وقد كان يمنى نفسه بتقبيل يد ذلك الفيلسوف الأديب بعد أن هام هو عشقا بعظمته التى تجلت في رواياته وقصصه والتى جعلت من تفرده فصلا في كتاب العظماء الحائزين على جائزة نوبل في الأدب لعام ١٩٨٨
وفي سياق الحديث عن محفوظ يأتى السؤال طارحا نفسه، ما الذي جعل أدبه يتملك نزعة الخلود؟ لماذا كان هو أوغيره ممن لا يقلون عبقرية عنه يسيرون في مضمار قد جعلهم جميعا جديرون بكلاسيكيتهم دون سواهم؟
حتى الثالث عشر من أكتوبر عام ١٩٨٨ حين تم إعلان فوز الأديب والفيلسوف نجيب محفوظ، لم يكن يفكر يوما في الجائزة بل وكان يعجب ممن يتهافتون على نيلها مستنكرا امتلاكهم “عقدة الخواجا” على حد قوله. ناهيك عن عدم سفره إلى السويد لتسلمها من الأساس. وبيت القصيد هو أن محفوظ، ومن على شاكلته، قد آمن بجوهر الكتابة، وهو أن الكاتب إنما يكتب لكي يقرأ القراء ما قد كتب وما يحويه من تجربته الحياتية الخاصة.
والمتأمل في كتابات محفوظ يرى أنه لم يكن يعرض كلماته كسلعة يشتريها من أراد أن يتشدق بثقافته و نضوجه الأجوف أمام أقرانه. فلم يقرأ لمحفوظ سوى من ألهمتهم كلماته و استفزتهم فلسفته وعمق أسلوبه الذي يحتاج إلى قاريء حقيقي قادر على معرفة ما إذا كان ذلك الكاتب كاتبا أو مجرد بائع كلمات.
محفوظ، ذلك الذي جاب القاهرة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، سيرا على الأقدام ولم يملك يوما سيارة فارهة أو حتى متهالكة. لقد كانت قدماه كبساط سحري يأخذه في زاوية تمكنه من رؤية دواخل الحياة القاهرية و الولوج إلى نوازع شخوصه النفسية حتى ترتسم أمام قرائه دون خلل أو انفصال عن الواقعية.
وحتى لا يقال أننا بصدد استعراض من قد فازوا بجائزة نوبل، إنما هى محض مصادفة، بل إن شئت فالتقل أن الجائزة تذهب لمثل هؤلاء الذين آمنوا دون سواهم من البشر بروح الكلمة وبأن للكلمة صوت يتردد في جنبات الكتب التى قد خلفوها وراءهم.
يصف إرنيست هيمينجواي، الفائز بجائزة نوبل عام ١٩٥٤، نفسه عندما تحدث عن الكتابة قائلا: ” كل ما يلزم فعله هو أن تكتب جملة صادقة، عليك أن تكتب أصدق الجمل التى تعرفها”
في الثامن من يوليو عام ١٩١٨ كان الشاب هيمينجواي في عامه الثامن عشر فقط، وقد كان يقود سيارة لإسعاف الجرحى في الجبهة الإيطالي في الحرب العالمية الأولى عندما أصبح هو ذاته أول أمريكي يصاب في الحرب العالمية الأولى. والذي جعله وكأنه يأخذ من دمه مدادا ليخط رائعته ” وداعا للحرب” كي يكتب بصدق عن ما قد عاشه بنفسه.
لكل من هؤلاء قصته المتفردة في سبر أغوار النفس البشرية والغوص في أعماقها وكأنهم شخص واحد لا يأفل نجمه في مكان أو زمان حتى يبزغ في آخر،
فاز الكولومبي جابريل جارسيا ماركيز بجائزة نوبل في العام ١٩٨٢ وقد كانت رائعته مائة عام من العزلة تحمل تعريفا فريدا للوطن حينما تحدث عن مفهوم الوطن عندما ربط كنهه بموت الأحباب الذين يواريهم ثراه. لطالما أخذنى ذلك التعريف إلى ذلك البعد الشعوري الذي يربطنى بذلك الحيز الذي أصبح حبه فطري دون أي اعتبارات أخرى قد يمحي فكرتها واقعا اجتماعيا، اقتصاديا يجعلنا رافضين الاعتراف به وطنا، حتى أتى ذلك التعريف ليدحض كل ما قد نعتقده منافيا لحقيقة أن الوطن يظل وطنا وإن كان في قعر الجحيم.
لم يكن هؤلاء كتابا فحسب،بل كانوا محاربين قد تدرعوا فلسفتهم واستلوا أقلامهم ضد وحش الرأسمالية البائس. لقد بذلوا بعبقرياتهم الكثير كي يجعلونا متصلين بأرواحنا، فنحس بأنينها المتصاعد تحت وطأة الجشع الرأسمالي الذي قد طال بسياطه كُتاب العصر الحالي والذين يجعلون من موهبتهم، حال إنها وجدت، كالبغي التي تتاجر بعفتها من أجل المال.
لقد كان هؤلاء أحرارا، لم يكونوا يوما براجماتيين أو عبيدا للمال، ولا عجب في ذلك فقد عانق الخلود كلماتهم التى قد خطتها أناملهم ولم يفكروا يوما في أن ذلك يكتب لغرض سوى الكتابة في حد ذاتها.
لقد كان هؤلاء الكلاسيكيون قد فازوا بحب الحياة الملأى بمن عانقوا أرواحهم في طيات كتبهم وفي كل كلمة صادقة تصور ما تهفو إلى تصوره النفس. لقد كانوا قراءا يقرؤون ويحللون، وكانوا بشرا يعيشون ويعرفون، وكانوا أحرارا يحاربون بكلمتهم ليس من أجل عصرهم فقط،، بل من أجل من سيليهم وقد ظلوا بين ظهرانيهم أحياءا بما قد خلفوه من أعمال قد يعجز عن فهمها الآلاف الذين ينشرون أعمال قد يشار لها بالبنان. فكيف لقاريء عاجز أن يكون كاتبا ذو رؤية؟ ولازلنا ننتظر خلف الأفق أن يأتي من يأخذنا في رحلة إلى أرواحنا التى جهلناها. فهل لمثل هؤلاء من سبيل؟




