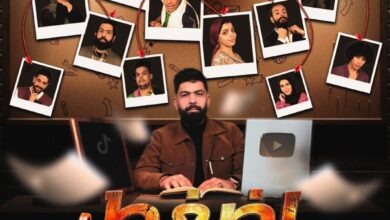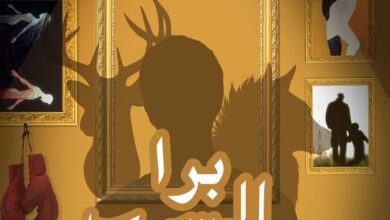السوفيت وعبدالناصر : من التحالف إلى دفع مصر نحو الحرب

✍️ بقلم : يوحنا عزمي
من خلال ملاحظاتي وتأملاتي حول ما جرى في أواخر الستينيات، أجد أن الاتحاد السوفيتي لعب دوراً محورياً في دفع مصر والرئيس جمال عبدالناصر إلى المسار الذي كان من الطبيعي أن يفضي في النهاية إلى الصدام مع إسرائيل.
بدلاً من أن يسعى السوفيت إلى التهدئة أو العمل على خفض التوتر ومنع الحرب ، اختاروا طريقاً مختلفاً تماماً. وأرى أن الأسباب التي قادت إلى هذا الموقف يمكن تتبعها في عدة محاور مترابطة.
فرغم كل ما شهدته العلاقات بين القاهرة وموسكو من تعاون واسع في مجالات التسليح والاقتصاد وغيرها، لم يكن عبدالناصر في نظر القيادة السوفيتية رجلهم المفضل في الشرق الأوسط.
فهو منذ قيام ثورة يوليو وحتى سنوات طويلة بعدها ظل ثابتاً على موقفه المعادي للشيوعية والشيوعيين داخل مصر، ولم يتردد في إيداعهم السجون والمعتقلات، مما أوقع القيادة السوفيتية ، وخاصة في عهد نيكيتا خروشوف ، في حرج بالغ.
فقد كانوا قد أنفقوا موارد ضخمة على تسليح الجيش المصري وبناء السد العالي وإقامة قاعدة صناعية واسعة بتمويل وخبرة سوفيتية ، وفي الوقت نفسه يرون أن حليفهم المفترض لا يشاركهم عقائدهم الفكرية ولا يسمح لهم بمد نفوذهم السياسي داخل مصر.
هذا التناقض كان من بين الأسباب التي عُدت ضمن ملفات اتهام خروشوف عند الإطاحة به ، حين اتُهم بأنه قدم مساعدات هائلة لمصر على حساب الشعب السوفيتي من دون أن يحقق للاتحاد أي مكاسب ملموسة. ولذلك لم يكن مستغرباً أن القيادة الجديدة التي خلفته لم تُظهر كثيراً من الحماسة تجاه عبدالناصر، بل بدت أقل تعاطفاً معه بكثير. فبينما كان بريجنيف، زعيم الحزب الشيوعي ، يتخذ موقفاً أكثر اعتدالاً ، كان كل من كوسيجين وبودجورني أكثر تحفظاً، ما جعل العلاقة تفقد الكثير من دفئها مقارنة بما كانت عليه في عهد خروشوف ، وتدخل مرحلة جديدة من إعادة التقييم التي تضع المصالح السوفيتية فوق أي اعتبار آخر.
ومع بروز قيادة بريجنيف ، كان الاتحاد السوفيتي يبحث عن حلفاء يمكن الاعتماد عليهم في استراتيجيته العالمية في مرحلة جديدة من الحرب الباردة. وكان من الواضح أن عبدالناصر، رغم مكانته الدولية الكبيرة وزعامته لحركة عدم الانحياز وقيادته للتيار القومي العربي في المنطقة، لم يكن يصلح في نظرهم ليكون شريكاً مطيعاً أو تابعاً. فهو لم يقبل في أي وقت أن يكون مجرد منفذ لسياسات السوفيت، لأن ذلك كان سيفقده هيبته ومكانته الدولية، ويضعف صورته أمام الشعوب العربية والأفريقية.
لذا ، لم يكن ضمن اختيارات موسكو كحليف موثوق، وربما كانت القيادة السوفيتية بالفعل تبحث عن بديل مستقبلي ، شخص آخر يمكن أن يستجيب لشروطها ويلعب الدور المطلوب في المنطقة ، لكنها آثرت الصمت وترك الأمر لتطورات الأحداث.
وفي هذه الأجواء ، كانت مصر غارقة في حرب اليمن التي استنزفت طاقاتها على مدى خمس سنوات، وأرهقت الجيش المصري بشرياً ومادياً ، وأثقلت كاهل الاقتصاد الوطني.
زاد الأمر سوءاً بعد أن قررت الولايات المتحدة في عهد جونسون وقف معوناتها الاقتصادية لمصر ، ما عمق من الأزمة وأدخل النظام الناصري في دوامة ضغوط متزايدة.
كل ذلك جعل السوفيت ينظرون إلى عبدالناصر باعتباره زعيماً أنهكته التجربة واستنفد طاقاته الثورية ، ولم يعد قادراً على تقديم المزيد لمصر أو للمنطقة. ومن هنا بدأ التفكير لديهم في البحث عن بدائل أو خيارات أخرى يمكن أن يراهنوا عليها.
ويبدو أن جزءاً من حساباتهم كان يقوم على فكرة أن جر مصر إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، قد تفتح الطريق لتغيير جذري في الداخل المصري. ففي تقديرهم ، فإن هزيمة مصر في حرب من هذا النوع كان من الممكن أن تفضي إلى مرحلة جديدة تسمح بوصول نظام حكم آخر يكون أكثر اعتماداً على الاتحاد السوفيتي ، وأكثر انصياعاً لسياساته وتوجهاته من نظام عبدالناصر.
قد يكون هذا السيناريو مجرد اجتهاد في التفسير ، وربما كانت هناك دوافع أخرى لم نكتشفها بعد ، لكن يبقى هذا الاحتمال قائماً في ضوء طبيعة الحسابات الاستراتيجية التي كانت تحكم عقل القيادة السوفيتية في ذلك الوقت.
وبهذا ، نجد أن الأسباب التي دفعت الاتحاد السوفيتي إلى توجيه الأمور نحو الصدام لم تكن وليدة لحظة عابرة ، بل جاءت نتيجة تراكمات سياسية وفكرية واستراتيجية.
وبينما كان عبدالناصر يحاول الحفاظ على استقلال قراره ورفض أن يتحول إلى تابع لأي قوة عظمى ، كانت موسكو تعيد ترتيب أوراقها وتبحث عن خيارات أكثر ملاءمة لمصالحها. أما القسم الآخر من هذه القصة ، فيتعلق بما قام به الاتحاد السوفيتي عملياً لدفع الأحداث باتجاه الحرب ، وهو ما يحتاج إلى وقفة منفصلة لرصده وتحليله.