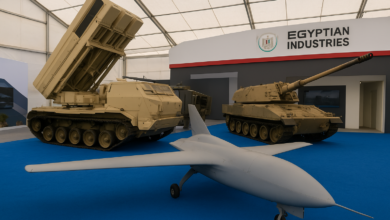ما بعد كامب ديفيد : تفكك الأولويات العربية وانحسار الصراع مع إسرائيل

✍️ يوحنا عزمي
تساءلنا طويلاً عمّا آلت إليه الأوضاع في المنطقة بعد اتفاقية كامب ديفيد ، وما الذي حدث على الساحة العربية عقب ذلك المنعطف الكبير. والحقيقة أن ما جرى لم يكن في الاتجاه الذي كان الكثيرون ينتظرونه أو يتوقعونه. فبدلاً من أن يتوجه الرئيس العراقي صدام حسين بجيشه نحو مواجهة إسرائيل – كما كان يُفترض أن يكون من أولويات الصراع العربي – قرر أن يزج بقدرات العراق العسكرية والاقتصادية في حرب ضروس مع إيران استمرت ثماني سنوات كاملة.
وقد دفعت العراق خلال تلك الحرب أبهظ الأثمان، من أرواح جنودها إلى مواردها الاقتصادية ، دون أن يكون هناك في ذلك الوقت مبرر استراتيجي حقيقي يفرض الدخول في هذا الصراع.
وتزداد المفارقة وضوحاً حين ندرك أن إيران ، بعد نجاح ثورتها الإسلامية في فبراير 1979، أغلقت السفارة الإسرائيلية في طهران وحولتها إلى سفارة لدولة فلسطين، في خطوة كان لها دلالاتها السياسية.
ومع انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية ، لم يلتفت صدام إلى أن العراق كان قد استنزف إلى الحد الأقصى ، بل اتخذ قراراً آخر كارثياً حين غزا الكويت ، فاتحاً الباب أمام تدخل التحالف الدولي الذي دمر جزءاً كبيراً من قدرات الجيش العراقي وفرض على البلاد حصاراً اقتصادياً هو الأعنف في تاريخها الحديث.
وهكذا انشغل العراق بقيادته وطموحات رئيسه الخاصة بالهيمنة والزعامة الإقليمية، مبتعداً تماماً عن مسار الصراع العربي–الإسرائيلي الذي كان يُفترض أن يحظى بالأولوية.
أما في سوريا ، فقد اتجه الرئيس حافظ الأسد في الاتجاه ذاته من الانشغال خارج محور المواجهة مع إسرائيل. فبدلاً من تركيز جهوده على تحرير الجولان التي ظلت محتلة منذ العام 1967، ذهب بجيشه إلى لبنان ليجعل منه منطقة نفوذ استراتيجي، وليدخل في تعقيدات الساحة اللبنانية الطويلة.
يضاف إلى ذلك أن علاقته مع النظام العراقي كانت مقطوعة تماماً نتيجة الصراع على قيادة حزب البعث، وهو صراع بلغ ذروته حين أعدم صدام حسين مجموعة من أبرز قيادات البعث العراقي في يوليو 1979 بدعوى تآمرهم مع الأسد.
وقد ساهم هذا الشرخ العميق بين بغداد ودمشق في إضعاف القدرتين السورية والعراقية معاً على مواجهة إسرائيل أو حتى التفكير في تنسيق استراتيجي يمكن أن يعيد التوازن في المنطقة. والمثير أنّ كل هذا التفكك حدث مباشرة بعد اتفاقية كامب ديفيد ، وكأن الصراع مع إسرائيل خرج من حسابات القيادتين كلياً.
أما العقيد معمر القذافي ، فقد اتجه في مسار آخر تماماً ، إذ انشغل بمغامرات خارجية امتدت من الفلبين إلى السودان، وساهم في تسليح جماعات مختلفة وجر المنطقة إلى نزاعات لم يكن لها أي صلة بالصراع مع إسرائيل.
وقد لعب دوراً خطيراً في تسليح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي تأجيج النزعة الانفصالية بين الجنوب والشمال، إضافة إلى أفكاره غير التقليدية كطرحه لمفهوم “إسراطين” الذي دعا فيه لدمج الفلسطينيين والإسرائيليين في دولة واحدة. وقد جاءت هذه المواقف انعكاساً لطبيعة شخصيته المثيرة للجدل، لا لاعتبارات استراتيجية تتعلق بالقضية الفلسطينية.
أما الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ، فقد ظل هو الآخر أسير حساباته الداخلية المعقدة ورهاناته الخليجية، التي جعلته يركز كل جهوده على ضمان بقائه في السلطة. ورغم أنه كان من أكثر من يرفعون شعارات الدفاع عن فلسطين ويزايدون بها في خطاباته ، فإن ارتباطه الحقيقي بالقضية كان شكلياً، أقرب للاستخدام السياسي منه لمعركة مصيرية.
وفيما يتعلق بدول الخليج العربية الست ، فقد كانت مشغولة بشكل شبه كامل بقضية أمنها الداخلي والخارجي في مواجهة التهديدات الإيرانية والعراقية ، لا في مواجهة إسرائيل. وقد كان هذا الهاجس الأمني هو الدافع الأساسي لتأسيس مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي عام 1981. وبذلك انغلقت هذه الدول على إطار أمني ضيق ، مبتعد عن منظومة الأمن القومي العربي الأشمل ، مما جعلها تتشكل ضمن أولويات خاصة وعلاقات خارجية مستقلة عن محور الصراع العربي–الإسرائيلي. ومن هنا تزايد البعد بينها وبين معركة المواجهة مع إسرائيل ، التي لم تكن تشكل تهديداً مباشراً لأمنها.
وبعد استعراض هذه المشاهد مجتمعة ، يبرز سؤال مهم : عن أي أمن قومي عربي جرى الحديث حين وُجهت الانتقادات إلى مصر؟ تلك الدولة التي خاضت الحروب تلو الحروب دفاعاً عن القضية الفلسطينية ، وقدمت من دماء جنودها واقتصادها ما لم تقدمه دولة عربية أخرى ، بل اعتبرت الدفاع عن فلسطين واجبها القومي الأول.
فهل كان مطلوباً منها أن تظل أراضيها محتلة وأن تبقى في حالة حرب منفردة إلى ما لا نهاية، بينما كان الآخرون منشغلين بصراعاتهم الجانبية ومصالحهم الذاتية؟
ثم أين هو هذا الأمن القومي العربي اليوم؟ خاصة حين نرى عدداً من الدول العربية تقيم علاقات سياسية واقتصادية واستراتيجية مع إسرائيل ، وتتعامل معها بوصفها الحليف والصديق ، معتبرة أن التهديد الأكبر لأمنها يأتي من إيران وبرنامجها النووي. فهل يمكن القول إن هذا التحول أيضاً هو من نتائج مسار كامب ديفيد ، بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على توقيعها؟